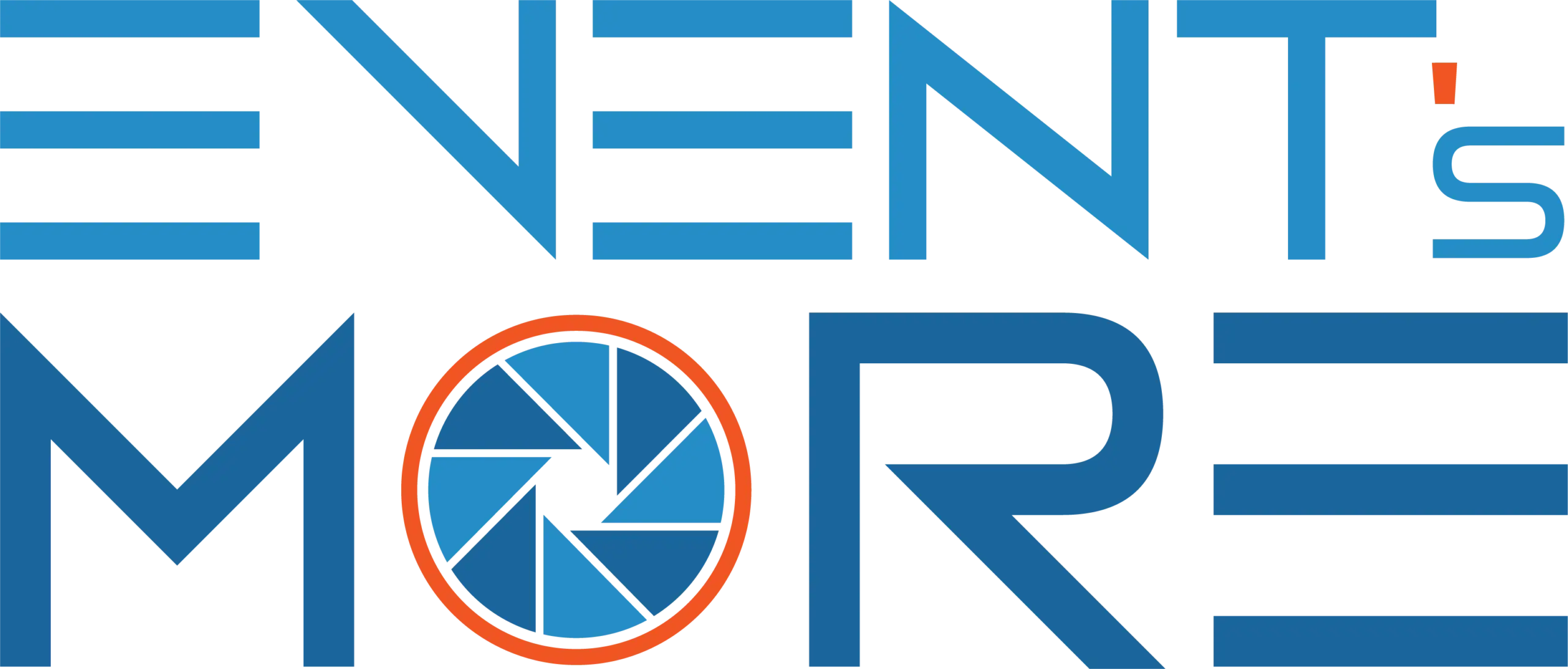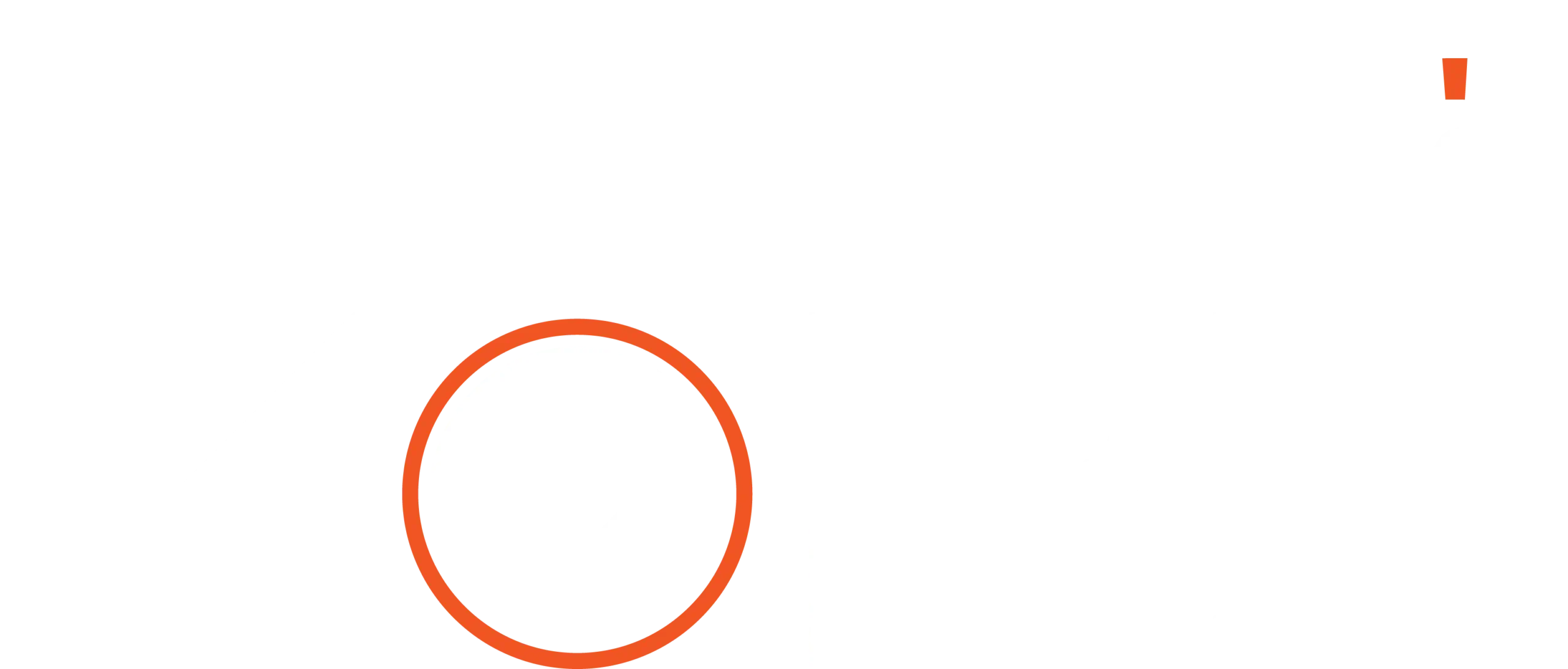بالصور.. كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية تنظم لقاءً حول تجربة أكاديمييها في الغربة

ضمن برنامج تواصل الثقافي في كلية اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حاضرَ كل من الدكتور صالح بن عويد العمري والدكتور محمد بن ظافر الحازمي عن تجربتهما الأكاديمية في بريطانيا.
وقد استفتح العمري اللقاء متحدثاً عن سؤال قديم جديد كان يُطرح عليهم وهو : كيف تدرس اللغة العربية في بريطانيا ؟ وما الذي يستفيده المرء من دراسة اللغة ؟
وتحدث عن تساؤل آخر وهو التأثر بالمستشرقين مجيباً عنه بأنّه قد يحدث لمن لم يكن مؤصلاً قبل ابتعاثه لكن من تأصل ثم اُبتعث ليأخذ تجربة الآخر ويناقشه ويتعاطى معه بإيجابية؛ فإنه بلا شك سيتأثر إيجابياً ويطّرح السلبيات. وأوضح أن تجربة كل واحد منهم مختلفة عن الآخر, وهي تجربة ذاتية في المقام الأول, والطالب لم يذهب هناك ليأخذ معلومة, بل ليأخذ التجربة.
وتحدث الدكتور محمد الحازمي عن محور اللغة والثقافة، مشيراً إلى أن العلماء عُنوا بالعلاقة بين اللغة والثقافة إذ هي وعاء الإدراك, والوعاء مؤثر فيما يحتويه، وتبدأ هذه الثنائية منذ وصول المبتعث إلى الجهة التي ابتُعث إليها، وتبدأ المقارنة بين لغته الأم واللغة التي يتعلمها ليبدأ رحلة الاستكشاف، ويبدأ في تعلم مصطلحات جديدة, طبقاً لحاجاته, ومن خلالها يكتسب عادات وثقافات جديدة مشيراً إلى أن أول ما يلفت الانتباه هو الوسائل التعليمية المتعددة والتي يود المبتعث لو نقلها للغته العربية ، إضافة إلى استراتيجيات الأساتذة والتقنيات والبرامج العمومية المتاحة للكل، وهذه ثقافة في نشر اللغة نحتاجها في تعليم لغتنا. كذلك لا يوجد هناك بون شاسع بين المعجم الموضوع في رفوف المكتبة وبين ما نستخدمه في الشارع، وهذه – يقول – دعوة لتقريب المعجم العربي من الواقع أو تقريب الواقع منه. فلهذا يبدأ الطالب التعلم بسرعة نظراً للواقعية بين المعجم والاستعمال اليومي، وكلما تعمق الشخص في تعلم اللغة ازداد معرفة في وسائل التواصل مع الآخر ممن لا يعرفهم, وفتح له ذلك آفاقاً كثيرة، ليشكل شبكة من العلاقات الناتجة عن تعلم اللغة، وفي المرحلة المتوسطة من إتقان اللغة يتمكن الإنسان من التواصل مع أي كان في العالم من المتخصصين وذلك بكتابة رسالة، وكذلك الاطلاع على ما كتب عن العربية باللغة الإنجليزية، وهناك مرحلة من إتقان اللغة يتمكن الطالب من خلالها من التكلم دون التفكير وبتلقائية، وهنا يبدأ الطالب بملاحظة الفروق في الثقافة, وضرب لذلك مثالاً معاشاً.
ثم تحدث عن مرحلة البناء العلمي، حيث يبدأ الطالب في هذه المرحلة بلقاء المشرف ليحدد مستوى الطالب العلمي ومعرفته بتخصصه، وربما يطلب منه حضور صفوف في لغة ثانية، ثم مرحلة التمحيص العلمي، ثم البداية التدريجية في الخطط ببناء فصل أول، ثم ينتج عنه الثاني، وهكذا حتى يكتمل البناء، ويكون المشرف هو من يطلب الإشراف على الطالب بناءً على اتصاله بالموضوع ووجود عنصر الشغف. ثم تحدث الدكتور صالح أن الابتعاث قبل كل شيء هو رحلة في طلب العلم, والاحتكاك بالعلماء وتجربتهم.
وعن محور البناء الإداري في الجامعات في الغرب، وأن نسبة القبول في الجامعة متدنية نظراً لعدم الحاجة إليها، وأن الجامعة لا يدخلها إلا من أراد أن يكون معلماً، وأن الجامعات تكون لها استقلالية مطلقة، وتكون خارج المدينة، وأن الطالب لا يعرف إدارة الجامعة، نظراً لأنه لا يحتاج إليها، فالمعاملة لا تتجاوز المشرف وشخصاً إدارياً.
وتحدث عن أن المستوى دعم الحكومة المالي للجامعة يتراوح بين 10% و 30% والباقي من الأوقاف، ومن براعة الاختراع والشراكة مع الجهات الثانية، والرسوم الدراسية من الطلاب الخارجيين، والنتيجة أن هناك جامعة مستقلة كلياً في رؤيتها وقراراتها.
ثم تحدث محمد الحازمي عن النشر العلمي وأن له معايير كثيرة، ومن ضمنها أن هناك برامج للدراسة في الدكتوراه مرتبطة بالنشر، فالطالب ينشر فصلاً من رسالته أو مبحثاً وحين ينتهي من رسالته يكون قد نشر بحثه كاملاً، وقد لا يحتاج مناقشة، وهناك النشر للأساتذة، وفيها تنوع من خلال البحوث المشتركة والخاصة، ومن معاييرها التوثيق من أصالة المقال، باستخدام برنامج معين ليعرف مدى استقلاله وجدته ومستوى النقل من الغير فيه، والحرص على عدم تجاوز نسبة 20% وإلا قدح ذلك في أصالة البحث.
وختم بأن التنوع سر التميز، وأن أي جهة ترى أنها ليست بحاجة إلى العالم ستجد نفسها مختلة، خاتماً بمقولة جون كيندي الشهيرة : إننا لا نذهب إلى الفضاء لأنه نزهة بل لأنه تحدٍ، وكذلك الابتعاث هو تحدٍ .